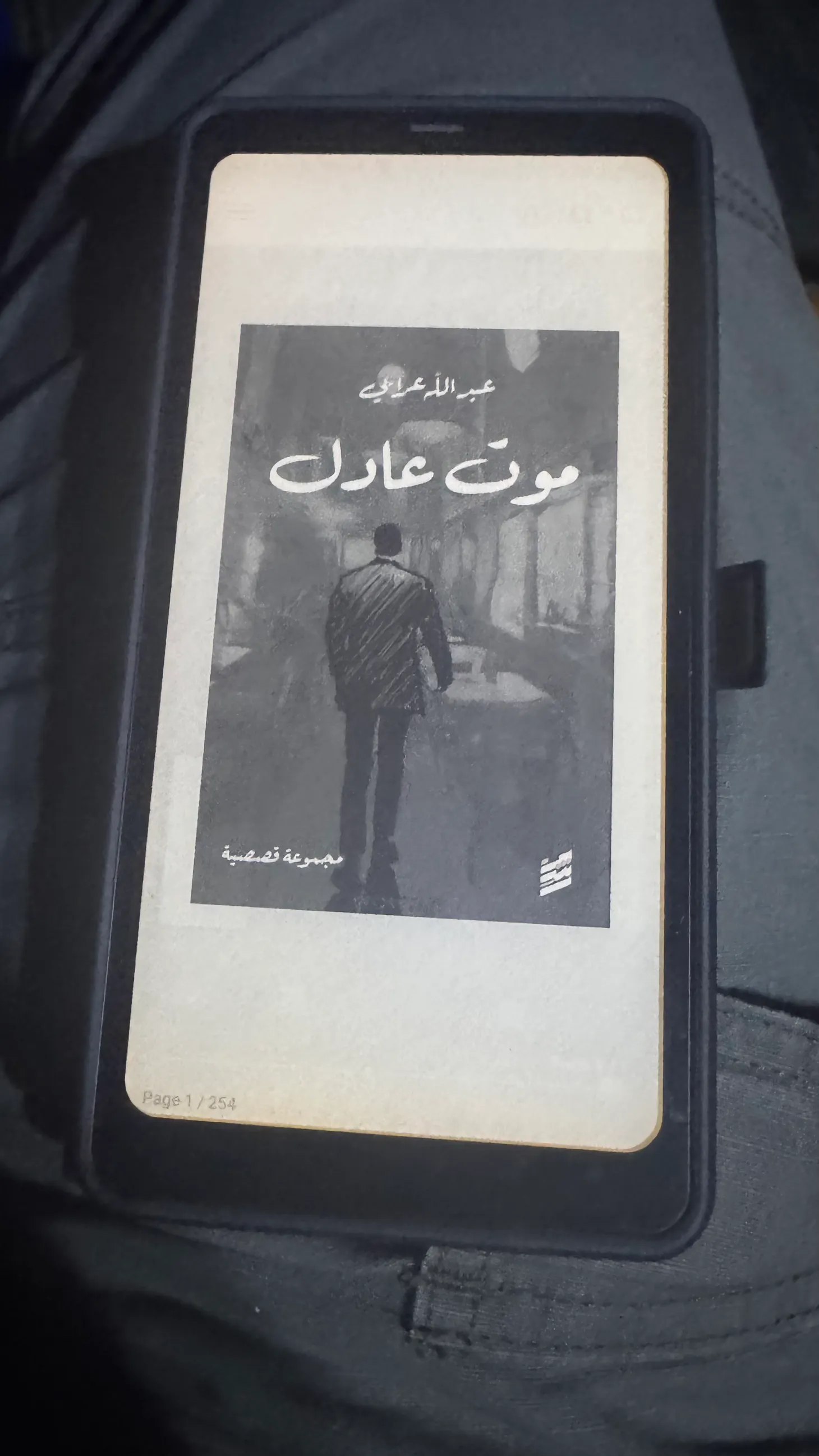لماذا الجهد لا يساوي النجاح؟
مشكلة الجهد المبذول كل يوم من قبل أي شخص يعمل على أي شيء لا يضمن أبداً النجاح لصاحبه، خصوصاً إن لم يقترن بأي مستوى فكري عالي. فتجد كما يعرف الجميع أشخاصاً يبذلون جهداً مضاعفاً تحت أشعة الشمس وبين الآلات مع مردود مادي ضعيف، وربما نجاحات قد لا تستحق الإشادة لدى الأغلبية الأُخرى.
لا أود التركيز على المفهوم في النقطة السابقة، لكن أود أن أترك المجال للقارئ الكريم بتخيل أن أياً من المهام اليومية التي يعمل بها سوآءاً كان موظفاً أو رجل أعمال أو فنان أو في غيرها من المهام؛ قد يصاب بالحسرة على نسخته التي كانت تعمل نفس العمل منذ خمسين عام. فموظف الحجوزات كان يعمل على الكثير من الأوراق والاتصالات والتواقيع (و«الأموال النقدية» التي تُصيبني بالمغص)، ومثله موظف البنك والبلدية وبائع السيارات، والتي اختُزلت معظم مهامهم دون الحاجة الماسة لاستخدام أوراق بوجود الكمبيوتر ونُظُم معلومات ساهمت دون مبالغة بتسريع عجلة العمل أكثر من عشرة أضعاف.
في الحقيقة لو تخيل القارئ الكريم هذا الأمر أو لم يتخيله فهذا لن يغير من واقع الأمر شيء؛ لأن العالم كله أصبح عندك … عند كبسة زر على الكمبيوتر (أو الهاتف الذكي).
وعن الإنجاز … تحدثت من قبل عن كتاب Deep Work للكاتب Cal Newport والذي تكلم فيه عن مفهوم بسيط وهو: أن الإنسان في هذا العصر أصبح يُصاب بوهم الإنجاز عندما يصرف معظم وقته في الإجابة على إيميلات العمل وإجراء بعض الاتصالات الهاتفية، في حين أن العمل الحقيقي والذي يحتاج للكثير من الجهد المبذول بتركيز أعلى لا يستوعب أهميته كثيراً من الناس.
فإن كان جزء من معادلة الإنجاز اليومي قد حُل بوجود التكنولوجيا؛ فهناك جزء آخر أصبح أكثر تعقيداً وهو أن صعوبة السيطرة على الملهيات المحيطة بنا كل دقيقة قد أعادنتا لنقص إنتاجي أو ما يعادل ما ينتجه الفرد قبل خمسين عام، فتجد إن كان الموظف المنتج ينجز خمسة معاملات مثلاً قبل خمسين سنة خلال يوم عمله (٨ ساعات)، فستجد – ربما – نفس الموظف ينجز ستة معاملات فقط في اليوم (خلال أقل من ساعتين) ويكتفي بها، ويعيش بقية اليوم تحت وهم الإنجاز وتضييع الوقت بالدردشة مع زملائه إضافةً إلى التلفونات والإيميلات … وبين قنوات التواصل الاجتماعي التي تسرق ثلث اليوم وربما أكثر مع الأمور الترفيهية الأخرى.
مشكلة الجهد المبذول خلال اليوم أنه أصبح بمعظم مستوياته بديهياً بالنسبة للشركة التي يعمل بها الموظف، أو بالنسبة لإنسان تعود على الكسل من خلال تعايشه مع محيطه. فها أنا مثلاً أصارع نفسي كل يوم لأكتب عدد الكلمات التي يجب أن أكتبها (١،٠٠٠ – ٢،٠٠٠ كلمة في اليوم الجيد) تكون موزعة ما بين تدقيقات لغوية، كتابات كتب وكتابة مقالات، في الوقت الذي ينبهر فيه أي شخص من حولي (حتى بعض أصدقائي الكُتاب) أن هذا الإنجاز يعتبر ذو وتيرة عالية نسبياً. لكن الحقيقة المحزنة تقول عكس ذلك!
فعدد ١،٠٠٠ كلمة يومياً يعتبر رقماً عادي لكاتب متمرس/متفرغ لدى الغرب، بل أن كُتاباً مثل تشارلز ديكينز ومارك وتوين وستيفن كينج وإسحاق آسيموڤ يكتبون على الأقل ٢،٠٠٠ كلمة يومياً (والأخير كان يكتب ٥،٠٠٠ كلمة معظم أيام حياته) دون أن ننسى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يواجهون مهمة كتابية أصعب بكتاباتهم على آلة كاتبة (باستثناء كينج) وليس على جهاز كمبيوتر يعالج أخطائهم ويرتب كلامهم على الصفحة. وعندما نقيس هذا الأمر على المهام الأخرى سنجد أن الرسامين ورجال الأعمال والمخترعين الذين لم يعاصروا التكنلوجيا يملكون وتيرة أعلى من الإنتاج في المقارنة مع الحاليين … وأعوز شخصياً السبب الذي قلته، بأن المهام أصبحت أسهل، لكن الملهيات أصبحت أكثر.
١،٠٠٠ كلمة مُنجزة يومياً والتي قد تبهر أي كاتب في مجتمعنا، ليست معياراً دقيق في الحقيقة، لأن المجتمع لم يتربى أصلاً على التعايش اليومي مع الفنون والمهام التي تتطلب حجماً أعلى من الالتزام وصرف الوقت عليها كالكتابة، فتجد أن السواد الأعظم منهم ينسجم مع الراحة أكثر من انسجامهم مع العمل المستمر.
الجهد لا يساوي النجاح …
أجريت إتفاقاً ضمنياً مع أهلي منذ سنتين على موضوع التسوق خلال شهر رمضان محاولاً أن أضمن من خلاله المزيد من الوقت لأنجز أعمالاً مهمة، إضافةً لامتلاكي حساسية عالية من النزول إلى السوق خصوصاً في هذا الشهر الكريم، وقد نص الاتفاق باختصار أنني على استعداد أن أطلب – بميزانية مفتوحة – أي شيء يريدونه «أون لاين» ليصلنا عبر البريد مقابل عدم نزولي معهم (أو عدم نزولهم) إلى السوق أبداً، وقد نجح الاتفاق بالفعل، ففي العام الماضي كنا قد طلبنا أكثر من ٣٠ قطعة ملابس للعائلة كلها من أحد مواقع التجزئة بمبلغ جيد في الحقيقة إضافةً إلى تكاليف الشحن التي لا أستخسرها أبداً مقابل «تعب القلب» الذي يتطلبه النزول إلى السوق. هذا الاتفاق أبعدني خطوات عن سلوك العقل الجمعي من المجتمع الذي يفضل الذهاب إلى الأسواق وقت الازدحام.
المشكلة الأخرى التي ظهرت بشكل أكبر هي … استمرار الملهيات بشكل أوسع، فلسبب ما أصبح الكثير من الأصدقاء يتعايشون مع رمضان بأنه شهر الخروج أثناء فترة المساء، وتمتلأ الفعاليات خلال النهار على قنوات التواصل الاجتماعي، لينقص معدل التركيز (ولو أن هذا الأمر هو مسؤوليتي الشخصية أولاً وأخيراً للسيطرة على التركيز والابتعاد عن الملهيات). ليقودني هذا الأمر إلى تساؤل آخر …
ماذا تفعل عندما تكون وحدك؟
«إن ما تفعلونه بمفردكم … هو ما يصنعكم» … قرأت هذه الجملة العميقة في سناب الآنسة الكريمة زينب الحميد، لتذكرني كثيراً بمفهوم كتاب «العمل العميق»، فالسر حقيقةً يختفي خلف الأوقات التي يكون فيها الإنسان بمفرده، فهل سيحرص على صرف ذلك الوقت على عمل حقيقي ذو تأثير عالي يستحق التركيز؟ … أم سينشغل في الملهيات مع الأعمال التي تشعر الواحد فينا بالإنجاز؟
كنت أقول دوماً: أن من عاش قبل خمسين سنة وأكثر كان يملك المساحة والقدرة الأكبر على الإنجاز لأنه ببساطة لا يملك نفس الملهيات التي نملكها اليوم، ليضرب لي أحد الأصدقاء مازحاً مثال «آينشتاين» الذي اشتهر عنه أنه كان زير نساء طول حياته، فالنساء – على حد قول صديقي – هم الأكثر إلهاءاً لرجل مهم مثل آينشتاين، لكن سيطرته اليومية الكبيرة على عمله وملهياته هي التي صنعت منه ما صنعت.
أختم ملاحظتي محاولاً الإجابة على سؤال المقالة، بأن الإنجاز (أو النجاح) لم يعد كما نعتقد أسهل من أي وقت مضى، فالتكنلوجيا خلقت سهولة العمل، وخلقت معها الكثير من الإلهاء، الذي يجب أن يحارب ضدها من يريد أن ينجز شيئاً حقيقي خلال يومه.
فالمشاريع لا تُخلق لوحدها دون عقل الإنسان وتركيزه المستمر (مستخدماً التكلنولوجيا) وهذه المقالة لم تكن ستكتب، لولا تركيز مستمر عليها مع الابتعاد عن الملهيات وقت كتاباتها.
الفرق اليوم في رأيي أصبح يتلخص بأن الإنسان يجب أن يركز على الأعمال الأكثر أهمية في حياته كما كان يركز عليها من هم مثلنا قبل خمسين سنة، بوجود التكنلوجيا أو بعدمها.
والنجاح … لا يأتي من خلال تنفيذ الأعمال المطلوبة منّا كل يوم كإرسال الإيميلات ومتابعة الاتصالات الهاتفية. بل بأخذ المخاطرة، والتعلم المستر، والتركيز على الإبداع والابتكار فيها، وإعطاء الآخرين أعمالاً متعوب عليها عقلياً قبل أن تكون جسدياً .. لنقول لهم تفضلوا … هذا عمل حقيقي، وليس وهم إنجاز.
المهام اليومية ليست عمل … التركيز المستمر على الأمور المهمة عمل.
النشرة الإخبارية
انضم إلى النشرة الإخبارية لتلقي آخر التحديثات.